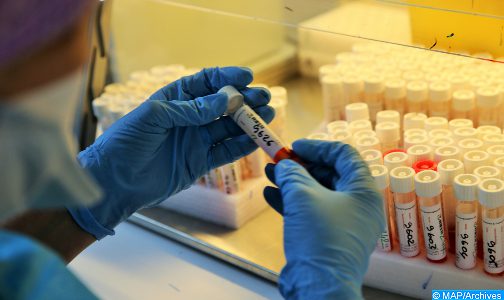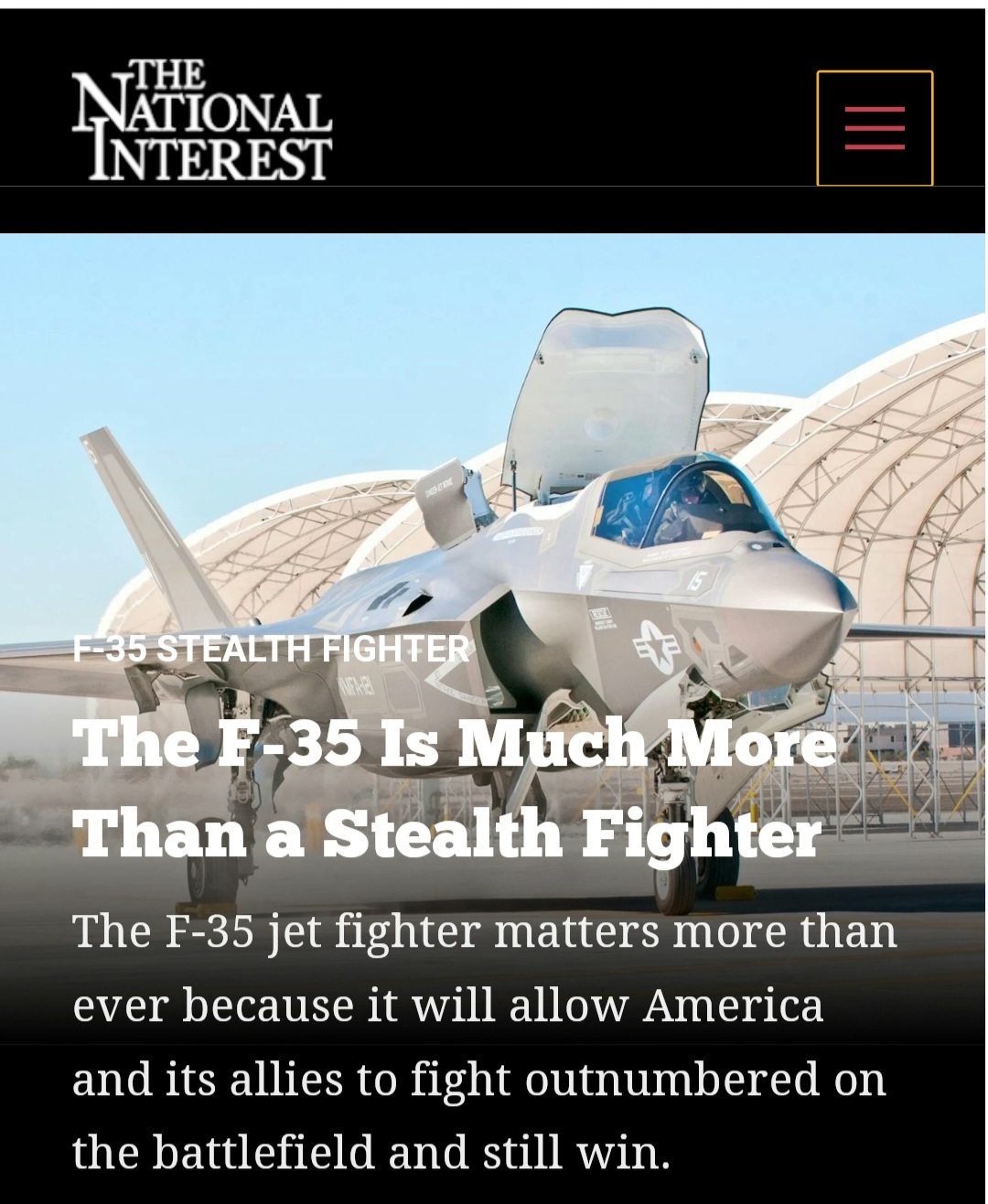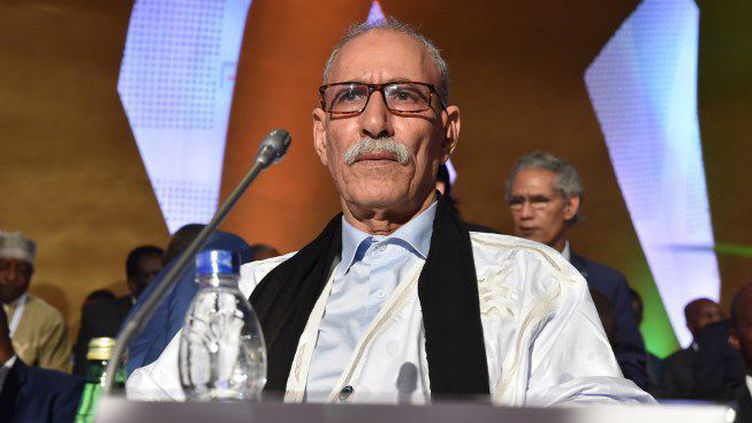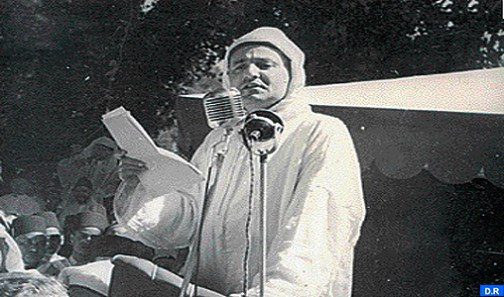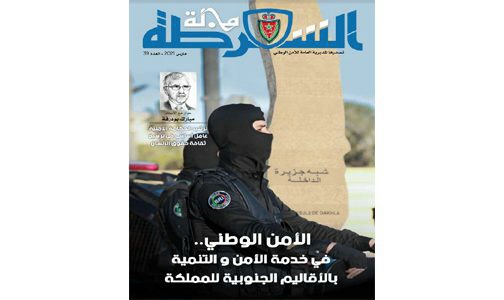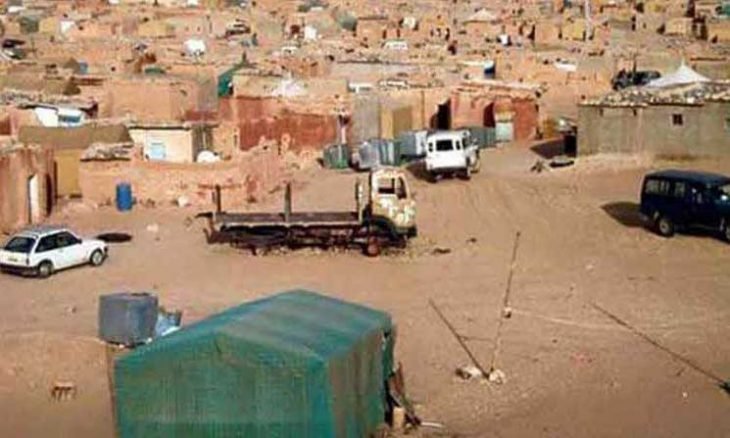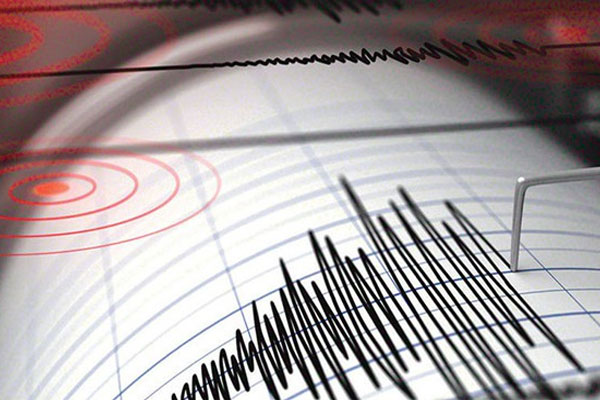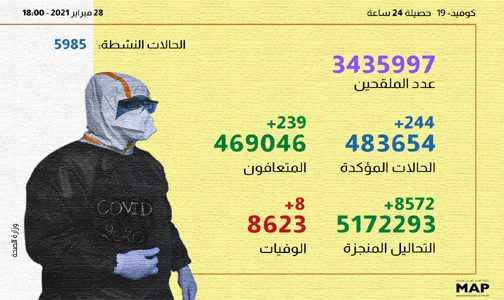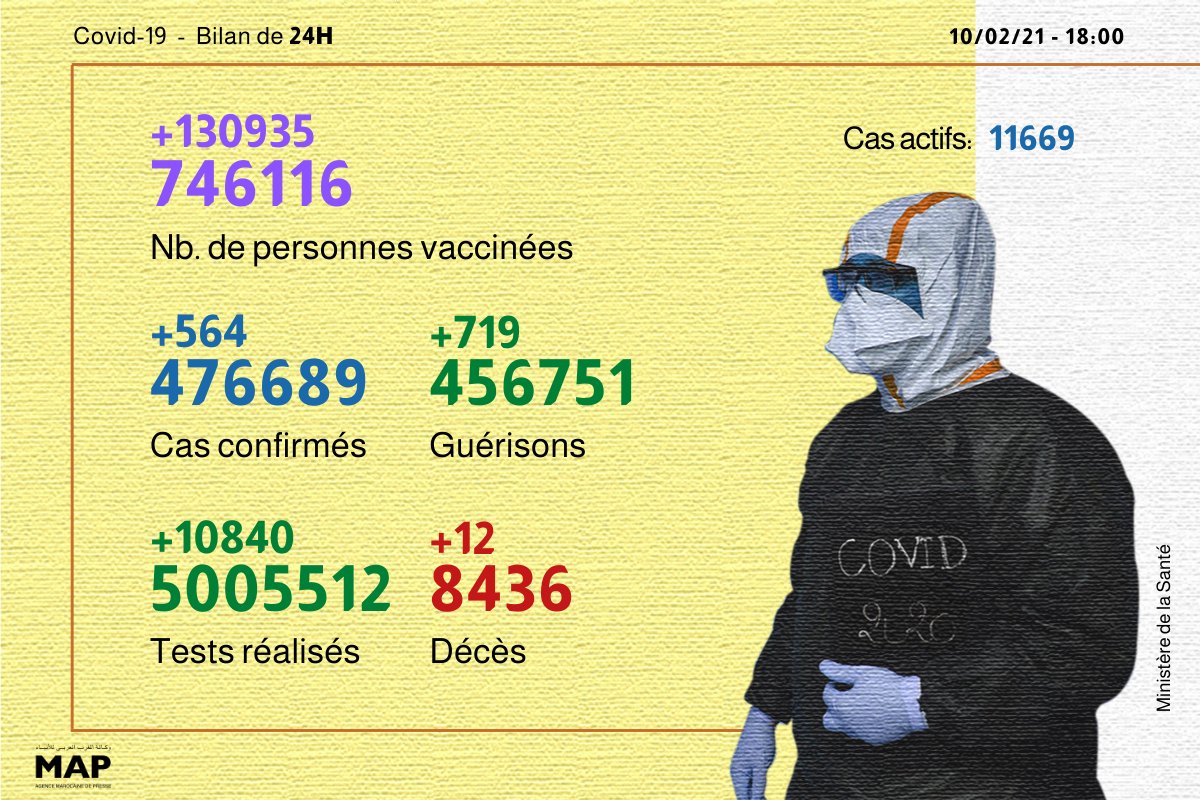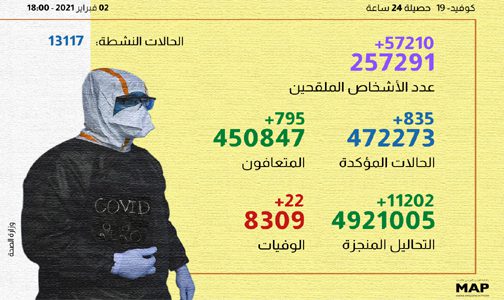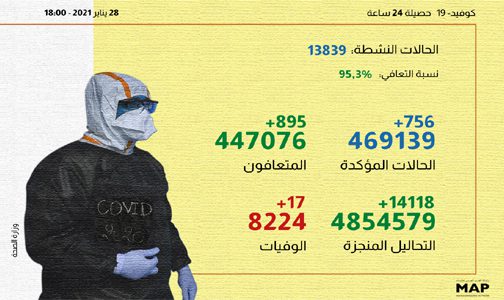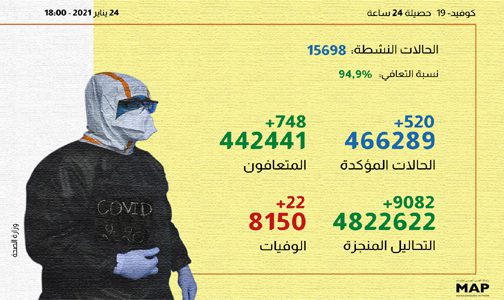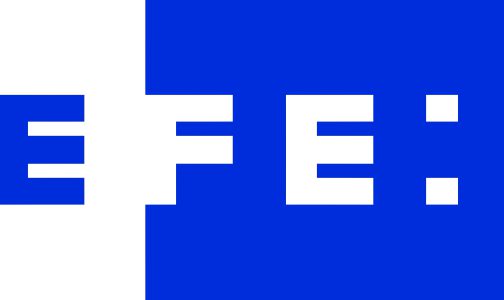عمر الشرقاوي: النظام الجزائري فقد الحد الأدنى من الأخلاق -فيديو-
بقلم: فهمي هويدة
لا جدال في أن خطاب اعتماد السفير المصري لدى إسرائيل يعد فضيحة للبيروقراطية المصرية، سببت إحراجا شديدا للرئيس محمد مرسي. مع ذلك فربما كان للحدث فضيلة وحيدة هي أنه يستدعي إلى الواجهة ملف العلاقات المصرية الإسرائيلية بعد ثورة 25 يناير.
(1)
إذ لم يخطر على بال أحد أن يخاطب أول رئيس منتخب لمصر بعد الثورة رئيس إسرائيل بعبارة: عزيزي وصديقي العظيم. وما تصور أحد أن يعبر الرئيس المصري عن مشاعره بقوله إنه: شديد الرغبة في اطراد علاقات المحبة التي تربط لحسن الحظ بلدينا..، إلى غير ذلك من مفردات وعبارات قاموس المرحلة التي كان فيها الرئيس المصري كنزا إستراتيجياً لإسرائيل. وهي المرحلة التي أسقطتها ثورة الشعب المصري، أملا منه في أن يقيم نظاما جديدا يرد للمصريين كرامتهم ويعيد لبلدهم كبرياءه الجريح.
رغم أني ممن يرون أنه ما كان لمصر أن تمثل بسفير في تل أبيب طالما استمرت الدولة العبرية في سياساتها التوسعية وفي احتلالها للأراضي العربية ورفضها لحقوق الشعب الفلسطيني، فإنني لم أتوقع أن تقطع مصر العلاقات مع إسرائيل وتلغي كامب ديفد، وتدخل بسببها حربا ضدها. مع ذلك فقد تصورت أنه من الطبيعي أن تتحدث مصر بعد الثورة بلغة تتسم بقدر من الاحتشام والحذر، تختلف في حدها الأدنى عن لغة النظام السابق. لغة ترى أن إسرائيل ليست صديقا ولا حليفا، ولكنها بلد غاصب ومعتدٍ، ورث النظام الجديد علاقة معه، فتورط فيها واضطر لأن يتعامل معها حتى إشعار آخر، باعتبار ذلك من قبيل السُّم الذي يضطر المرء إلى تجرعه في بعض الظروف الاستثنائية. ولذلك فإن موقف مصر الحقيقي بعد الثورة هو الصبر عليها وليس الموافقة عليها.
يقول خبراء الدبلوماسية المصرية إن لغة الخطاب الذي أرسل مع السفير الجديد ليس فيها جديد، لأنها الصيغة التقليدية المتعارف عليها دوليا، والتي يخاطب بها كل رؤساء الجمهوريات في أنحاء العالم، من الولايات المتحدة إلى بوركينا فاسو. فالنص مكتوب منذ عدة عقود، والذي يتغير فيه فقط بين الحين والآخر هو اسم رئيس الدولة الموجه إليه الخطاب، واسم السفير الذي يحمله. ذلك يعني أن الخطاب المرسل ليس فيه أية مشاعر خاصة بإسرائيل. وبالتالي فإنه من التعسف والظلم أن يعد الخطاب دليلا على استمرار الرئيس مرسي في السير على ذات النهج الذي خطَّه وسار عليه الرئيس السابق.
هذا الكلام أفهمه ومستعد للقبول به، لكنه يعني في الوقت ذاته أن البيروقراطية المصرية في غيبوبة، ولم تدرك بعد أن في مصر ثورة أقامت نظاما جديدا، وبالتالي فإن لغة مخاطبة رئيس إسرائيل من جانب أول رئيس منتخب بعد الثورة المصرية لابد من أن تختلف في مفرداتها ومعانيها.
(2)
أستطيع أن أفهم أيضا أن العلاقات المصرية الإسرائيلية لها وضع شديد الحساسة والخصوصية، لسبب جوهري هو أنها ليست علاقة ثنائية بين دولتين، ولكنها علاقة ثلاثية بل ورباعية أيضا. أعني أن تعامل المسؤول المصري مع إسرائيل يضع في الاعتبار أنه يتعامل أيضا مع طرف ثالث هو الولايات المتحدة، بل وطرف رابع يتمثل في الاتحاد الأوروبي. وبالتالي فعليه أن يدرك أن مسار علاقات مصر مع إسرائيل يمكن أن يؤثر سلبا أو إيجابا مع الولايات المتحدة وأوروبا.
وذلك أمر لا ينبغي أن يصادر حركة الدبلوماسية المصرية، لكنه يدعوها إلى توخي الحذر فيما تقدم عليه من خطوات. والحذر لا يكون بالاستسلام والانبطاح بطبيعة الحال، وإنما يكون بدوام التمسك بالحق مع الحرص على الحفاظ على الجسور الممتدة مع الولايات ودول الاتحاد الأوروبي.
ولست أشك في أن استقرار الوضع الداخلي وتماسكه يمثل عنصرا مهما في نجاح المسعى المصري المنشود. ولا أقول إن وراءه شعوب الأمة العربية، لكن يكفي أن تتوافر له قيادة منتخبة ديمقراطيا ومعبرة عن ضمير المجتمع، الذي لديه ألف تحفظ على الممارسات الإسرائيلية. علما بأن الذي تصالح مع إسرائيل هو حكومة مصرية ليست منتخبة، في حين أن الشعب لم يتصالح معها منذ وقعت الاتفاقية في عام 1979.
يحضرني هنا موقف الحكومة التركية التي اجتازت ذلك الاختبار بنجاح مشهود. إذ هي محتفظة بعلاقاتها التي ورثتها مع إسرائيل، وعلاقتها وثيقة مع الولايات المتحدة بحكم عضويتها في ملف الناتو. لكن ذلك لم يمنعها من الاشتباك مع الاثنين والدخول في مواجهات سياسية ساخنة، حين يتعلق الأمر باستقلال السياسة التركية، خصوصا في موقفها من الوضع الفلسطيني.
وما كان لحكومة أنقرة أن تخوض غمار تلك المواجهات إلا لأن قيادتها توافرت لديها الإرادة المستقلة، كما توافر لها السند الشعبي القوي بعد النجاحات والإنجازات التي حققتها في الداخل. والاستقبال الشعبي الكبير الذي حظي به رئيس الوزراء الطيب أردوغان بعد اشتباكه العلني مع الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز في مؤتمر دافوس، يشهد بأن موقف الرجل كان تعبيرا صادقا عن ضمير الشعب التركي الذي انتخبه.
ليس لدي اعتراض على من يقول إن مصر في وضعها الراهن تصعب مقارنتها بتركيا، وهو ما أوافق عليه، لكن أقول فقط إننا إذا لم نفعلها فلا أقل من أن نفهمها.
(3)
منذ بدأت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عقب توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل في عام 1979 أرسلت مصر ستة سفراء إلى تل أبيب، لكن هذه هي المرة الأولى التي تنشر فيها الصحف الإسرائيلية خطاب اعتماد السفير المصري لدى الدولة العبرية.
من العبط أن نعتبرها مجرد مصادفة. ومن السذاجة أن نتصور أن الرسالة لم تسرب عمدا لإحراج الرئيس محمد مرسي وتشويه صورته أمام الرأي العام العربي والإسلامي، فضلا عن محاولة طمأنة الرأي العام الداخلي إلى أن رئيس مصر بعد الثورة ليس سوى نسخة من رئيسها قبل الثورة، لم يختلف عنه إلا في لحيته البيضاء.
ولست أشك في أن من سرب الرسالة أراد أن يقول للعرب والمسلمين جميعا ها هو الرئيس القادم من جماعة الإخوان المسلمين التي حاربت إسرائيل في عام 48 ولا تزال أجنحتها في غزة وفي غيرها من البلدان، ها هو يبعث برسالة صداقة دافئة وحميمة إلى “صديقه العظيم” رئيس إسرائيل. كأنه يعتذر عن ماضيه وماضي جماعته، ويطلب منهم الصفح والغفران، ملتمسا إقامة علاقات المحبة وطالبا الرضا والقرب.
قارئ الصحف المصرية على الأقل يدرك أن أغلب المنابر الإعلامية ابتلعت الطعم، وتصرفت كأن خطاب الاعتماد كتبه الرئيس محمد مرسي بخط يده، وأن العبارات التي وردت فيه تعبير عن مشاعره الحقيقية، التي كان قد أخفاها قبل الانتخابات الرئاسية حيث دعا إلى وقف التطبيع مع إسرائيل. بل قرأت أن الإخوان سوف ينخرطون في عملية التطبيع قريبا، وأن لقاء الدكتور مرسي مع شمعون بيريز لن يكون بعيدا.
الخلاصة أن عددا كبيرا من المعلقين في وسائل الإعلام المصري شغلوا بمحاكمة الرئيس مرسي واحتساب هدف ضد الإخوان، بأكثر مما شغلوا بتحري الحقيقة في شأن الخطاب، أو بالتفكير في كيفية التعاطي بمسؤولية وكرامة مع ملف العلاقات المصرية الإسرائيلية في ظل موازين القوة الحالية.
(4)
لا أخفي شعورا بالاستياء والحنق إزاء اللغة التي يتحدث بها الرئيس والحكومة في مصر بعد الثورة عن معاهدة السلام والعلاقات مع إسرائيل. وقد حزنت كثيرا عندما سمعت الرئيس محمد مرسي يقول في نيويورك إنه ليست لديه مشكلة مع اتفاقية كامب ديفد، لثقتي في أنه لابد من أن تكون له مشكلة مع المعاهدة، شأنه في ذلك شأن أي وطني مصري، كما أن لدي تحفظا على قول المتحدث باسم الرئاسة وكذلك السفير الجديد لدى إسرائيل إن مصر ملتزمة بالكامل ببنود المعاهدة.
وقبل أن يصيح المرتعشون والمطبعيون قائلين إنني أدعو إلى إلغاء المعاهدة والدخول في حرب ضد إسرائيل، فإنني أكرر أن ما أدعو إليه في الوقت الراهن ليس إلغاء المعاهدة، وإنما الحذر في الحديث عنها والاستسلام لها بغير تحفظ.
لقد قال لي بعض الدبلوماسيين المخضرمين إن ذلك الحديث الذي أثار استيائي ليس موجها إلى إسرائيل، ولكنه موجه لطمأنة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وحتى إذا كان ذلك صحيحا، فإنه يبعث أيضا برسالة طمأنة مفرطة لإسرائيل، كما أنه يشيع حالة من الإحباط في أوساط الوطنيين المصريين والعرب، ناهيك عن الفلسطينيين في الأرض المحتلة.
إن ما بيننا وبين إسرائيل ليس علاقات عادية، وبالتالي فإن مخاطبة رئيسها ينبغي أن تضع في الاعتبار الظروف الاستثنائية التي تحيط بتلك العلاقات، فإسرائيل مستمرة كل يوم في محو خريطة فلسطين حتى أعلنت مؤخرا أن الضفة الغربية ليست أرضا محتلة، وذلك لا يمثل فقط إهدارا لحقوق الفلسطينيين الذين تحتفظ في سجونها بنحو عشرة آلاف منهم، ولكنه يمثل أيضا تهديدا للأمن المصري والقومي العربي -ولا تزال إسرائيل تحاصر قطاع غزة بعدما دمرت بنيته التحتية- ثم إن شبه جزيرة سيناء لا تزال مرتهنة لحساب إسرائيل، ولم تستطع مصر أن تستعيد سيادتها عليها منذ توقيع اتفاقية السلام، رغم أن الأحداث التي وقعت أخيرا بينت خطورة استمرار ذلك الوضع على الأمن المصري، ولا يقل عن ذلك أهمية أن إسرائيل صارت طرفا في نهب حقوق الغاز التي تم اكتشافها داخل نطاق المياه الاقتصادية المصرية بالتواطؤ مع قبرص. وهي جريمة كبرى ضيعت على مصر دخلا يقدر بعشرات المليارات من الدولارات، في حين أنها تقف على باب صندوق النقد الدولي متمنية الحصول على أقل من خمسة مليارات دولار للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها (للعلم لم تنزعج إسرائيل من قرار الحكومة المصرية وقف تصدير الغاز إليها، لأنها استعاضت عنه بالغاز المنهوب وبدأت تصدر منه!).
هذه الخلفية لا ترشح العلاقات المصرية الإسرائيلية لأي تقدم، بل لا تسوغ التعجل في إرسال سفير إلى تل أبيب اكتفاءً بوجود قائم بالأعمال هناك، كما أنها لا تبرر بأي حال إرسال خطاب اعتماد مع السفير الجديد يصف الرئيس الإسرائيلي بأنه صديق عزيز أو وفي. وإنما تفرض على المسؤول المصري أيا كان أن يحذف من خطابه مثل تلك الصفات غير المبررة. والمجال واسع في التحفظ المطلوب في حديث المسؤول المصري عن معاهدة السلام. فله أن يقرن كلامه عن الالتزام بها بالدعوة إلى ضرورة وفاء الطرف الآخر بالتزاماته، مع التأكيد على ضرورة احترام حقوق الفلسطينيين، وبالتساؤل عن طبيعة “السلام” الذي جلبته.
في هذا الصدد، يجدر الانتباه إلى أنه لا توجد معاهدات أبدية، ولكن المعاهدات تخضع للتعديل بما يلبي مصالح أطرافها لكي يعيشوا في أمان وسلام. وقد كان ذلك أوضح ما يكون في حالة سيناء التي أثبتت الظروف أن ثمة حاجة ملحة لإعادة النظر في الملحق الأمني للاتفاقية ليحقق مزيدا من الوجود والسيطرة الأمنية المصرية فيها.
لا تثريب على مصر إن تحدثت بهذه اللغة حتى تتعافي وتنهض على قدميها، وحينذاك ربما أصبح بمقدورها أن تفعل ما فعلته تركيا مع أصدقائها و”أعدائها”.
المصدر: الجزيرة.نت